“هذا الصيف، احتج طلاب اليمين المتطرف على إحدى محاضراتي. أعاد خطابهم إلى الأذهان بعضا من أحلك اللحظات في تاريخ القرن 20 – وتداخل مع وجهات النظر الإسرائيلية السائدة إلى درجة صادمة.”
في 12 ذو الحجة 1445هـ (19 يونيو 2024م)، كان من المقرر أن ألقي محاضرة في جامعة بن غوريون في النقب (BGU) في بئر السبع، إسرائيل. كانت محاضرتي جزءا من حدث حول احتجاجات الحرم الجامعي في جميع أنحاء العالم ضد إسرائيل، وخططت لمعالجة الحرب في غزة وعلى نطاق أوسع مسألة ما إذا كانت الاحتجاجات تعبيرا صادقا عن الغضب أو مدفوعة بمعاداة السامية، كما ادعى البعض. لكن الأمور لم تسر كما هو مخطط لها.
عندما وصلت إلى مدخل قاعة المحاضرات، رأيت مجموعة من الطلاب يتجمعون. سرعان ما اتضح أنهم لم يكونوا هناك لحضور الحدث ولكن للاحتجاج عليه. يبدو أنه تم استدعاء الطلاب من خلال رسالة واتساب التي خرجت في اليوم السابق ، والتي أشارت إلى المحاضرة ودعت إلى التحرك: “لن نسمح بذلك! إلى متى سنرتكب الخيانة ضد أنفسنا?!?!?!??!!”
ومضت الرسالة لتزعم أنني وقعت على عريضة تصف إسرائيل بأنها “نظام فصل عنصري” (في الواقع، أشارت العريضة إلى نظام فصل عنصري في الضفة الغربية). كما أنني “اتهمت” بكتابة مقال لصحيفة نيويورك تايمز، في ربيع الآخر 1445هـ (نوفمبر 2023م)، ذكرت فيه أنه على الرغم من أن تصريحات القادة الإسرائيليين تشير إلى نية الإبادة الجماعية، إلا أنه لا يزال هناك وقت لمنع إسرائيل من ارتكاب الإبادة الجماعية. في هذا الصدد، كنت مذنبا كما لو أني متهم. كما تعرض منظم الحدث، الجغرافي البارز أورن يفتاخيل، لانتقادات مماثلة. وشملت جرائمه عمله مديرا لمنظمة “بتسيلم” “المناهضة للصهيونية”، وهي منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان تحظى باحترام عالمي.
عندما دخل المشاركون في اللجنة وحفنة من أعضاء هيئة التدريس معظمهم من كبار السن إلى القاعة، منع حراس الأمن الطلاب المحتجين من الدخول. لكنهم لم يمنعوهم من إبقاء باب قاعة المحاضرات مفتوحا، وإطلاق شعارات على قرن ثور والطرق بكل قوتهم على الجدران.
بعد أكثر من ساعة من الاضطراب، اتفقنا على أنه ربما تكون أفضل خطوة إلى الأمام هي مطالبة الطلاب المحتجين بالانضمام إلينا لإجراء محادثة، بشرط أن يوقفوا التعطيل. دخل عدد لا بأس به من هؤلاء النشطاء في نهاية المطاف وجلسنا وتحدثنا خلال الساعتين التاليتين. وكما اتضح فيما بعد، فإن معظم هؤلاء الشبان والشابات قد عادوا مؤخرا من الخدمة الاحتياطية، التي تم نشرهم خلالها في قطاع غزة.
ولم يكن هذا تبادلا وديا أو “إيجابيا” للآراء، ولكنه كان كاشفا. لم يكن هؤلاء الطلاب بالضرورة ممثلين للهيئة الطلابية في إسرائيل ككل. كانوا نشطاء في منظمات يمينية متطرفة. لكن ما كانوا يقولونه يعكس من نواح كثيرة شعورا أكثر انتشارا في البلاد.
لم أذهب إلى إسرائيل منذ ذي القعدة 1444هـ (يونيو 2023م)، وخلال هذه الزيارة الأخيرة وجدت بلدا مختلفا عن البلد الذي عرفته. على الرغم من أنني عملت في الخارج لسنوات عديدة، إلا أن إسرائيل هي المكان الذي ولدت وترعرعت فيه. إنه المكان الذي عاش فيه والداي ودفنا. إنه المكان الذي أسس فيه ابني عائلته الخاصة ويعيش معظم أقدم وأفضل أصدقائي. وبمعرفتي بالبلد من الداخل ومتابعتي للأحداث عن كثب أكثر من المعتاد منذ 22 ربيع الأول (7 تشرين الأول/أكتوبر)، لم أفاجأ تماما بما صادفته عند عودتي، ولكنه كان لا يزال مزعجا للغاية.
أنا وعند مناقشة هذه القضايا، لا يسعني إلا أن أعتمد على خلفيتي الشخصية والمهنية. خدمت في جيش الدفاع الإسرائيلي لمدة أربع سنوات، وهي فترة شملت حرب يوم الغفران عام 1393هـ (1973م) وتعييناتي في الضفة الغربية وشمال سيناء وغزة، منهيا خدمتي كقائد سرية مشاة. خلال الفترة التي قضيتها في غزة، رأيت فقر اللاجئين الفلسطينيين ويأسهم وهم يعيشون في أحياء مكتظة ومتهالكة. أتذكر بوضوح شديد أنني كنت أقوم بدوريات في الشوارع الصامتة والمظللة في بلدة العريش المصرية – التي احتلتها إسرائيل آنذاك – التي اخترقتها نظرات السكان الخائفين والمستائين الذين يراقبوننا من نوافذهم المغلقة. لأول مرة، فهمت ما يعنيه احتلال شعب آخر.
الخدمة العسكرية إلزامية لليهود الإسرائيليين عندما يبلغون 18 عاما – على الرغم من وجود استثناءات قليلة – ولكن بعد ذلك، لا يزال من الممكن استدعاؤك للخدمة مرة أخرى في جيش الدفاع الإسرائيلي، للتدريب أو الواجبات التشغيلية، أو في حالات الطوارئ مثل الحرب. عندما تم استدعائي في عام 1396هـ (1976م)، كنت طالبا جامعيا أدرس في جامعة تل أبيب. خلال ذلك الانتشار الأول كضابط احتياطي، أصبت بجروح خطيرة في حادث تدريب، إلى جانب عدد من جنودي. تستر جيش الدفاع الإسرائيلي على ملابسات هذا الحادث الناجم عن إهمال قائد قاعدة التدريب. قضيت معظم ذلك الفصل الدراسي الأول في مستشفى بئر السبع، لكنني عدت إلى دراستي، وتخرجت في عام 1399هــ (1979م) بتخصص في التاريخ.
جعلتني هذه التجارب الشخصية أكثر اهتماما بسؤال شغلني منذ فترة طويلة: ما الذي يحفز الجنود على القتال؟ في العقود التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، جادل العديد من علماء الاجتماع الأمريكيين بأن الجنود يقاتلون أولا وقبل كل شيء من أجل بعضهم البعض، وليس من أجل هدف أيديولوجي أكبر. لكن هذا لم يتناسب تماما مع ما اختبرته كجندي: كنا نعتقد أننا كنا في ذلك من أجل قضية أكبر تجاوزت مجموعتنا من الأصدقاء. بحلول الوقت الذي أكملت فيه شهادتي الجامعية، بدأت أيضا أسأل عما إذا كان، باسم هذه القضية، يمكن إجبار الجنود على التصرف بطرق قد يجدونها تستحق الشجب.
إذا أخذنا الحالة القصوى، فقد كتبت أطروحة الدكتوراه في أكسفورد، والتي نشرت لاحقا ككتاب، عن التلقين النازي للجيش الألماني والجرائم التي ارتكبها على الجبهة الشرقية في الحرب العالمية الثانية. ما وجدته يتعارض مع كيفية فهم الألمان في ثمانينيات القرن العشرين ماضيهم. لقد فضلوا الاعتقاد بأن الجيش قد خاض حربا “لائقة”، حتى عندما ارتكب الجستابو وقوات الأمن الخاصة الإبادة الجماعية “من وراء ظهره”. استغرق الأمر من الألمان سنوات عديدة أخرى لإدراك مدى تواطؤ آبائهم وأجدادهم في الهولوكوست والقتل الجماعي للعديد من الجماعات الأخرى في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي.
عندما اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الأولى في 1408هـ (أواخر عام 1987م) كنت أدرس في جامعة تل أبيب. لقد روعني توجيه إسحاق رابين، وزير الدفاع آنذاك، إلى جيش الدفاع الإسرائيلي بأن “يكسر أذرع وأرجل” الشبان الفلسطينيين الذين كانوا يرشقون القوات المدججة بالسلاح. كتبت له رسالة أحذره فيها من أنه، بناء على بحثي في تلقين القوات المسلحة لألمانيا النازية، كنت أخشى أن الجيش الإسرائيلي تحت قيادته يسير في طريق زلق مماثل.
لدهشتي، بعد أيام قليلة من الكتابة إليه، تلقيت ردا من سطر واحد من رابين، يوبخني لتجرؤي على مقارنة الجيش الإسرائيلي بالجيش الألماني. وقد منحني ذلك الفرصة لأكتب له رسالة أكثر تفصيلا، أشرح فيها بحثي وقلقي من استخدام الجيش الإسرائيلي كأداة لقمع المدنيين العزل المحتلين. ورد رابين مرة أخرى، بنفس العبارة: “كيف تجرؤ على مقارنة الجيش الإسرائيلي بالفيرماخت”. لكن في وقت لاحق، أعتقد أن هذا التبادل كشف شيئا عن رحلته الفكرية اللاحقة. لأنه كما نعلم من مشاركته اللاحقة في عملية أوسلو للسلام، مهما كانت معيبة، فقد أدرك في النهاية أنه على المدى الطويل لا يمكن لإسرائيل أن تتحمل الثمن العسكري والسياسي والأخلاقي للاحتلال.
وفي الأشهر التي تلت 22 ربيع الأول (7 تشرين الأول/أكتوبر)، أصبح ما تعلمته على مدار حياتي وحياتي المهنية أكثر إيلاما من أي وقت مضى. مثل كثيرين آخرين، وجدت أن هذه الأشهر الأخيرة صعبة عاطفيا وفكريا. ومثل كثيرين آخرين، تأثر أفراد أسرتي وعائلات أصدقائي بشكل مباشر بالعنف. لا يوجد ندرة في الحزن أينما اتجهت.
جاء هجوم حماس في 22 ريع الأول (7 أكتوبر) بمثابة صدمة هائلة للمجتمع الإسرائيلي، وهي صدمة لم يبدأ في التعافي منها. كانت هذه هي المرة الأولى التي تفقد فيها إسرائيل السيطرة على جزء من أراضيها لفترة طويلة من الزمن. إن الشعور بتخلي الدولة عن البلاد واستمرار انعدام الأمن – حيث لا يزال عشرات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين مشردين من منازلهم على طول قطاع غزة وعلى الحدود اللبنانية – عميق.
اليوم، عبر قطاعات واسعة من الجمهور الإسرائيلي، بما في ذلك أولئك الذين يعارضون الحكومة، يسود شعوران سائدان.
الأول هو مزيج من الغضب والخوف، والرغبة في إعادة إرساء الأمن بأي ثمن، وانعدام الثقة التام في الحلول السياسية والمفاوضات والمصالحة. أشار المنظر العسكري كارل فون كلاوزفيتز إلى أن الحرب كانت امتدادا للسياسة بوسائل أخرى ، وحذر من أنه بدون هدف سياسي محدد سيؤدي إلى دمار لا حدود له. وعلى نحو مماثل، يهدد الشعور السائد الآن في إسرائيل بجعل الحرب في نهايتها. ومن وجهة النظر هذه، تشكل السياسة عقبة أمام تحقيق الأهداف وليست وسيلة للحد من الدمار. هذه وجهة نظر لا يمكن أن تؤدي إلا في النهاية إلى إبادة الذات.
الشعور الثاني السائد – أو بالأحرى الافتقار إلى المشاعر – هو الجانب الآخر من الأول. إنه العجز التام للمجتمع الإسرائيلي اليوم عن الشعور بأي تعاطف مع سكان غزة. ويبدو أن الأغلبية لا تريد حتى معرفة ما يحدث في غزة، وتنعكس هذه الرغبة في التغطية التلفزيونية. عادة ما تبدأ أخبار التلفزيون الإسرائيلي هذه الأيام بتقارير عن جنازات الجنود، الذين يوصفون دائما بأنهم أبطال، سقطوا في القتال في غزة، تليها تقديرات لعدد مقاتلي حماس الذين تم “تصفيتهم”. إن الإشارات إلى وفيات المدنيين الفلسطينيين نادرة وعادة ما يتم تقديمها كجزء من دعاية العدو أو كسبب لضغوط دولية غير مرحب بها. في مواجهة الكثير من الموت، يبدو هذا الصمت الذي يصم الآذان الآن وكأنه شكل خاص به من الانتقام.
بالطبع، أصبح الجمهور الإسرائيلي منذ فترة طويلة معتادا على الاحتلال الوحشي الذي ميز البلاد لمدة 57 عاما من أصل 76 عاما من وجودها. لكن حجم ما يرتكبه الجيش الإسرائيلي في غزة الآن لم يسبق له مثيل مثل اللامبالاة الكاملة لمعظم الإسرائيليين بما يتم القيام به باسمهم. في عام 1402هـ (1982م)، احتج مئات الآلاف من الإسرائيليين على مذبحة السكان الفلسطينيين في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين في غرب بيروت على يد الميليشيات المسيحية المارونية، بتسهيل من جيش الدفاع الإسرائيلي. واليوم، لا يمكن تصور هذا النوع من الاستجابة. إن الطريقة التي تلمع بها عيون الناس كلما ذكر المرء معاناة المدنيين الفلسطينيين، وموت الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، أمر مقلق للغاية.
عند لقائي بأصدقائي في إسرائيل هذه المرة، شعرت مرارا وتكرارا أنهم كانوا خائفين من أن أعطل حزنهم، وأن بسبب عيشي خارج البلاد لم أستطع فهم آلامهم وقلقهم وحيرتهم وعجزهم. كان الانطباع الذي حصلت عليه ثابتا: ليس لدينا مكان في قلوبنا، وليس لدينا مكان في أفكارنا، لا نريد أن نتحدث أو أن نظهر ما يفعله جنودنا أو أطفالنا أو أحفادنا، إخواننا وأخواتنا، الآن في غزة. يجب أن نركز على أنفسنا، على صدمتنا وخوفنا وغضبنا.
في مقابلة أجريت في 26 شعبان 1445هـ (7 مارس 2024م)، عبر الكاتب والمزارع والعالم زئيف سميلانسكي عن هذا الشعور بالذات بطريقة وجدتها صادمة، على وجه التحديد لأنها جاءت منه. لقد عرفت سميلانسكي منذ أكثر من نصف قرن، وهو ابن الكاتب الإسرائيلي الشهير س. يزهار، الذي كانت روايته “خربة خيزة” عام 1368هـ (1949م) أول نص في الأدب الإسرائيلي يواجه ظلم النكبة، وطرد 750 ألف فلسطيني مما أصبح دولة إسرائيل في عام 1367هـ (1948م). وفي حديثه عن ابنه أوفر، الذي يعيش في بروكسل، علق سملانسكي قائلاً:
“يقول العرض أن كل طفل بالنسبة له هو طفل، بغض النظر عما إذا كان في غزة أو هنا. لا أشعر مثله. أطفالنا هنا أكثر أهمية بالنسبة لي. هناك كارثة إنسانية مروعة هناك، وأنا أفهم ذلك، لكن قلبي مسدود ومليء بأطفالنا ورهائننا… لا يوجد مكان في قلبي للأطفال في غزة، مهما كان الأمر صادما ومرعبا، وعلى الرغم من أنني أعرف أن الحرب ليست هي الحل.
أستمع إلى معوز إينون، الذي فقد والديه [قتلتهما حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول]… والذي يتحدث بشكل جميل ومقنع عن الحاجة إلى التطلع إلى الأمام، وأننا بحاجة إلى جلب الأمل والرغبة في السلام، لأن الحروب لن تحقق أي شيء، وأنا أتفق معه. أتفق معه، لكنني لا أستطيع أن أجد القوة في قلبي، مع كل ميولي اليسارية وحبي للإنسانية، لا أستطيع … ليست حماس وحدها، بل كل سكان غزة هم الذين يوافقون على أنه لا بأس من قتل الأطفال اليهود، وأن هذه قضية جديرة بالاهتمام… مع ألمانيا كانت هناك مصالحة، لكنهم اعتذروا ودفعوا تعويضات، وماذا [سيحدث] هنا؟ نحن أيضا فعلنا أشياء فظيعة، ولكن لا شيء يقترب مما حدث هنا في 7 تشرين الأول/أكتوبر. سيكون من الضروري التوفيق ولكننا بحاجة إلى بعض المسافة.”
كان هذا شعورا سائدا بين العديد من الأصدقاء والمعارف ذوي الميول اليسارية والليبرالية الذين تحدثت معهم في إسرائيل. كان، بالطبع، مختلفا تماما عما يقوله السياسيون اليمينيون والشخصيات الإعلامية منذ 7 أكتوبر. العديد من أصدقائي يعترفون بظلم الاحتلال، وكما قال سميلانسكي، يعلنون “حبهم للإنسانية”. لكن في هذه اللحظة، في ظل هذه الظروف، ليس هذا ما يركزون عليه. بدلا من ذلك، يشعرون أنه في الصراع بين العدالة والوجود، يجب أن ينتصر الوجود، وفي الصراع بين قضية عادلة وأخرى – قضية الإسرائيليين وقضية الفلسطينيين – فإن قضيتنا هي التي يجب أن تنتصر، بغض النظر عن الثمن. بالنسبة لأولئك الذين يشككون في هذا الاختيار الصارخ، يتم تقديم المحرقة كبديل، مهما كانت غير ذات صلة باللحظة الحالية.
ولم يظهر هذا الشعور فجأة في 7 تشرين الأول/أكتوبر. جذورها أعمق بكثير.
في 19 رمضان 1375هـ (30 أبريل 1956م)، ألقى موشيه ديان، رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي آنذاك، خطابا قصيرا سيصبح أحد أشهر الخطابات في تاريخ إسرائيل. وكان يخاطب المشيعين في جنازة روعي روثبرغ، وهو ضابط أمن شاب في كيبوتس ناحال عوز الذي تأسس حديثا، والذي أنشأه الجيش الإسرائيلي في عام 1370هـ (1951م) وأصبح مجتمعا مدنيا بعد ذلك بعامين. كان الكيبوتس يقع على بعد بضع مئات من الأمتار من الحدود مع قطاع غزة، مقابل حي الشجاعية الفلسطيني.
وكان روثبرغ قد قتل في اليوم السابق، وسحبت جثته عبر الحدود وشوهت، قبل إعادتها إلى أيدي الإسرائيليين بمساعدة الأمم المتحدة. أصبح خطاب ديان بيانا مبدعا، يستخدمه كل من اليمين واليسار السياسي حتى يومنا هذا:
“صباح أمس قتل روعي. مبهورا بهدوء الصباح، لم ير أولئك الذين ينتظرون في كمين له على حافة الثلم. دعونا لا نلقي الاتهامات على القتلة اليوم. لماذا يجب أن نلومهم على كراهيتهم الشديدة لنا؟ إنهم يسكنون منذ ثماني سنوات في مخيمات اللاجئين في غزة، كما حولنا أمام أعينهم الأرض والقرى التي سكنوا فيها هم وأجدادهم إلى ممتلكات خاصة بنا.
لا ينبغي أن نطلب دماء روا من العرب في غزة بل من أنفسنا. كيف أغمضنا أعيننا ولم نواجه مصيرنا بصراحة، ولم نواجه مهمة جيلنا بكل قسوتها؟ هل نسينا أن هذه المجموعة من الفتيان، الذين يسكنون في ناحال عوز، يحملون على أكتافهم أبواب غزة الثقيلة، التي تزدحم على جانبها الأخرى بمئات الآلاف من العيون والأيدي التي تصلي من أجل لحظة ضعفنا، حتى يتمكنوا من تمزيقنا – هل نسينا ذلك؟…
نحن جيل الاستيطان. بدون خوذة فولاذية وكمامة المدفع، لن نتمكن من زرع شجرة وبناء منزل. لن يعيش أطفالنا إذا لم نحفر الملاجئ، وبدون الأسلاك الشائكة والمدافع الرشاشة لن نتمكن من تعبيد الطرق وحفر آبار المياه. ملايين اليهود الذين أبيدوا لأنهم لا يملكون أرضا ينظرون إلينا من رماد التاريخ الإسرائيلي ويأمروننا بالاستيطان وإحياء أرض لشعبنا. ولكن وراء ثلم الحدود يرتفع محيط من الكراهية والرغبة في الانتقام، في انتظار اللحظة التي سيضعف فيها الهدوء استعدادنا، لليوم الذي نستمع فيه إلى سفراء النفاق المتآمرين، الذين يدعوننا إلى إلقاء أسلحتنا …
دعونا لا نتوانى عن رؤية الكراهية التي ترافق وتملأ حياة مئات الآلاف من العرب الذين يسكنون حولنا وينتظرون اللحظة التي يمكنهم فيها الوصول إلى دمائنا. دعونا لا نتجنب أعيننا لئلا تضعف أيدينا. هذا هو مصير جيلنا. هذا هو خيار حياتنا – أن نكون مستعدين ومسلحين وأقوياء. لأنه إذا سقط السيف من قبضتنا، فسوف تقطع حياتنا.”
وفي اليوم التالي، سجل ديان خطابه للإذاعة الإسرائيلية. لكن شيئا ما كان مفقودا. لقد ولت الإشارة إلى اللاجئين الذين يشاهدون اليهود يزرعون الأراضي التي طردوا منها والذين لا ينبغي لومهم على كرههم لتجريدهم. على الرغم من أنه نطق بهذه السطور في الجنازة وكتبها لاحقا، اختار ديان حذفها من النسخة المسجلة. هو أيضا كان يعرف هذه الأرض قبل عام 1367هـ (1948م). وأشار إلى القرى والبلدات الفلسطينية التي دمرت لإفساح المجال للمستوطنين اليهود. لقد فهم بوضوح غضب اللاجئين عبر السياج. لكنه كان يؤمن أيضا إيمانا راسخا بكل من الحق والحاجة الملحة للاستيطان اليهودي وإقامة الدولة. في الصراع بين معالجة الظلم والاستيلاء على الأرض، اختار جانبه، مع العلم أنه حكم على شعبه بالاعتماد إلى الأبد على البندقية. كان ديان يعرف جيدا ما يمكن أن يقبله الجمهور الإسرائيلي. وبسبب تناقضه حول مكان الشعور بالذنب والمسؤولية عن الظلم والعنف، ونظرته الحتمية والمأساوية للتاريخ، انتهى الأمر بنسختين من خطابه إلى جذب توجهات سياسية مختلفة إلى حد كبير.
بعد عقود، بعد العديد من الحروب وأنهار الدماء، عنون ديان كتابه الأخير “هل يلتهم السيف إلى الأبد؟” نشر الكتاب في عام 1401هـ (1981م)، وفصل دوره في التوصل إلى اتفاق سلام مع مصر قبل عامين. لقد تعلم أخيرا حقيقة الجزء الثاني من الآية التوراتية التي أخذ منها عنوان الكتاب: “ألا تعلم أنه سيكون مرارة في النهاية الأخيرة؟”
في 23 ربيع الأول 1445هـ (8 أكتوبر 2023م)، خاطب الرئيس إسحاق هرتسوغ الجمهور الإسرائيلي، مستشهدا بالسطر الأخير من خطاب ديان: “هذا هو مصير جيلنا. هذا هو خيار حياتنا – أن نكون مستعدين ومسلحين وأقوياء. لأنه إذا سقط السيف من قبضتنا، فسوف تقطع حياتنا”. وفي اليوم السابق، بعد 67 عاما من وفاة روعي، قتل مقاتلو حماس 15 من سكان كيبوتس ناحال عوز واحتجزوا ثمانية رهائن. منذ الغزو الإسرائيلي الانتقامي لغزة، تم إفراغ حي الشجاعية الفلسطيني المواجه للكيبوتس، حيث كان يعيش 100,000 شخص، من سكانه وتحويله إلى كومة كبيرة من الأنقاض.
بالإضافة إلى رؤية العائلة، جئت أيضا إلى إسرائيل لمقابلة الأصدقاء. كنت آمل أن أفهم ما حدث في البلاد منذ بدء الحرب. لم تكن المحاضرة المجهضة في جامعة BGU على رأس جدول أعمالي. ولكن بمجرد وصولي إلى قاعة المحاضرات في ذلك اليوم من منتصف يونيو، فهمت بسرعة أن هذا الوضع المتفجر يمكن أن يوفر أيضا بعض الأدلة لفهم عقلية جيل الشباب من الطلاب والجنود.
بعد أن جلسنا وبدأنا في الحديث، أصبح من الواضح لي أن الطلاب يريدون أن يسمع صوتهم، وأنه لا أحد، ربما حتى أساتذتهم ومديري الجامعات، كان مهتما بالاستماع. إن وجودي، ومعرفتهم الغامضة بانتقادي للحرب، قد دفعوا فيهم إلى أن يشرحوا لي، ولكن ربما أيضا لأنفسهم، ما كانوا يشاركون فيه كجنود وكمواطنين.
قفزت امرأة شابة، عادت مؤخرا من الخدمة العسكرية الطويلة في غزة، على المسرح وتحدثت بقوة عن الأصدقاء الذين فقدتهم، والطبيعة الشريرة لحماس، وحقيقة أنها ورفاقها كانوا يضحون بأنفسهم لضمان سلامة البلاد في المستقبل. في حالة ذهول عميق، بدأت في البكاء في منتصف خطابها وتنحت. رفض شاب اقتراحي بأن انتقاد السياسات الإسرائيلية لم يكن بالضرورة مدفوعا بمعاداة السامية. ثم انطلق في مسح موجز لتاريخ الصهيونية كرد على معاداة السامية وكمسار سياسي لا يحق لأي من الوثنيين إنكاره. في حين أنهم كانوا منزعجين من آرائي ومنزعجين من تجاربهم الأخيرة في غزة، إلا أن الآراء التي عبر عنها الطلاب لم تكن استثنائية بأي حال من الأحوال. لقد عكسوا قطاعات أكبر بكثير من الرأي العام في إسرائيل.
مع العلم أنني حذرت سابقا من الإبادة الجماعية، كان الطلاب حريصين بشكل خاص على إظهار أنهم كانوا إنسانيين، وأنهم ليسوا قتلة. لم يكن لديهم شك في أن جيش الدفاع الإسرائيلي كان، في الواقع، الجيش الأكثر أخلاقية في العالم. لكنهم كانوا مقتنعين أيضا بأن أي ضرر يلحق بالناس والمباني في غزة له ما يبرره تماما، وأن كل ذلك كان خطأ حماس في استخدامهم كدروع بشرية.
أطلعوني على صور على هواتفهم لإثبات أنهم تصرفوا بشكل مثير للإعجاب تجاه الأطفال، ونفوا وجود أي جوع في غزة، وأصروا على أن التدمير المنهجي للمدارس والجامعات والمستشفيات والمباني العامة والمساكن والبنية التحتية ضروري ومبرر. لقد اعتبروا أي انتقاد للسياسات الإسرائيلية من قبل الدول الأخرى والأمم المتحدة مجرد معاداة للسامية.
وخلافا لغالبية الإسرائيليين، رأى هؤلاء الشباب تدمير غزة بأعينهم. بدا لي أنهم لم يستوعبوا فقط وجهة نظر معينة أصبحت شائعة في إسرائيل – وهي أن تدمير غزة على هذا النحو كان ردا مشروعا على 7 أكتوبر – ولكنهم طوروا أيضا طريقة تفكير كنت قد لاحظتها منذ سنوات عديدة عند دراسة السلوك والنظرة العالمية والتصور الذاتي لجنود الجيش الألماني في الحرب العالمية الثانية. بعد أن استوعبت وجهات نظر معينة عن العدو – البلاشفة على أنهم Untermenschen ؛ حماس كحيوانات بشرية – ومن بين السكان الأوسع باعتبارهم أقل من البشر وغير مستحقين للحقوق ، يميل الجنود الذين يراقبون أو يرتكبون الفظائع إلى نسبها ليس إلى جيشهم، أو إلى أنفسهم، ولكن إلى العدو.
قتل الآلاف من الأطفال؟ إنه خطأ العدو. أطفالنا قتلوا؟ هذا بالتأكيد خطأ العدو. إذا ارتكبت حماس مجزرة في كيبوتس، فهي نازية. إذا أسقطنا قنابل تزن 2000 رطل على ملاجئ اللاجئين وقتلنا مئات المدنيين، فهذا خطأ حماس للاختباء بالقرب من هذه الملاجئ. بعد ما فعلوه بنا، ليس لدينا خيار سوى اجتثاثهم. بعد ما فعلناه بهم، لا يمكننا إلا أن نتخيل ما سيفعلونه بنا إذا لم ندمرهم. ببساطة ليس لدينا خيار.
بعد يومين من هجوم حماس، أعلن وزير الدفاع يوآف غالانت “نحن نقاتل البشرية، ويجب أن نتصرف وفقا لذلك”، مضيفا في وقت لاحق أن إسرائيل “ستقسم حيا تلو الآخر في غزة”. وأكد رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت: “نحن نقاتل النازيين”. وحث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإسرائيليين على “تذكر ما فعله عماليق بكم”، في إشارة إلى الدعوة التوراتية لإبادة “رجال ونساء وأطفال ورضع عماليق”. في مقابلة إذاعية، قال عن حماس: “أنا لا أسميهم بشرية لأن ذلك سيكون مهينا للحيوانات”. وكتب نائب رئيس الكنيست نسيم فاتوري على موقع إكس أن هدف إسرائيل يجب أن يكون “محو قطاع غزة من على وجه الأرض”. وقال في التلفزيون الإسرائيلي: “لا يوجد أشخاص غير متورطين … يجب أن نذهب إلى هناك ونقتل، نقتل، نقتل. يجب أن نقتلهم قبل أن يقتلوننا”. وشدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في كلمة “يجب استكمال العمل… الدمار الشامل. “امسح ذكر عماليق من تحت السماء”. وتحدث آفي ديختر، وزير الزراعة والرئيس السابق لجهاز المخابرات الشاباك، عن “تنفيذ نكبة غزة”. ومنح الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ شهادة تكريم لجندي إسرائيلي محارب قديم يبلغ من العمر 95 عاما، حثهم في خطابه التحفيزي أمام جنود جيش الدفاع الإسرائيلي الذين يستعدون لغزو غزة على “محو ذكراهم وأسرهم وأمهاتهم وأطفالهم”، “لتقديمه مثالا رائعا لأجيال من الجنود”. لا عجب أن هناك عددا لا يحصى من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في غزة تدعو إلى “قتل العرب” و “حرق أمهاتهم” و “تسوية” غزة. لم يكن هناك أي إجراء تأديبي معروف من قبل قادتهم.
هذا هو منطق العنف الذي لا نهاية له، وهو منطق يسمح للمرء بتدمير شعوب بأكملها والشعور بأن له ما يبرره تماما في القيام بذلك. إنه منطق الضحية – يجب أن نقتلهم قبل أن يقتلوننا ، كما فعلوا من قبل – ولا شيء يمكن العنف أكثر من الشعور الصالح بالضحية.
كان الشبان والشابات الذين تحدثت معهم في ذلك اليوم ممتلئين بالغضب، ليس ضدي كثيرا – لقد هدأوا قليلا عندما ذكرت خدمتي العسكرية – ولكن لأنهم، على ما أعتقد، شعروا بالخيانة من قبل كل من حولهم. خيانة من قبل وسائل الإعلام، التي اعتبروها انتقادية للغاية، من قبل كبار القادة الذين اعتقدوا أنهم متساهلون للغاية تجاه الفلسطينيين، من قبل السياسيين الذين فشلوا في منع الفشل الذريع في 7 أكتوبر، من قبل عجز الجيش الإسرائيلي عن تحقيق “النصر الكامل”، من قبل المثقفين واليساريين الذين ينتقدونهم بشكل غير عادل، من قبل حكومة الولايات المتحدة لعدم تسليم ذخائر كافية بالسرعة الكافية، ومن قبل كل هؤلاء السياسيين الأوروبيين المنافقين والطلاب المعادين للسامية الذين يحتجون على أفعالهم في غزة. بدوا خائفين وغير آمنين ومرتبكين، ومن المحتمل أن يكون بعضهم يعاني أيضا من اضطراب ما بعد الصدمة.
بحلول الوقت الذي سافرت فيه إلى إسرائيل، كنت قد أصبحت مقتنعا بأنه على الأقل منذ الهجوم الذي شنه جيش الدفاع الإسرائيلي على رفح في 27 شوال 1445هـ (6 مايو 2024م)، لم يعد من الممكن إنكار أن إسرائيل متورطة في جرائم حرب منهجية وجرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة جماعية. لم يقتصر الأمر على أن هذا الهجوم ضد آخر تجمع لسكان غزة – معظمهم نزحوا بالفعل عدة مرات من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي، الذي دفعهم الآن مرة أخرى إلى ما يسمى بالمنطقة الآمنة – أظهر تجاهلا تاما لأي معايير إنسانية. كما أشار بوضوح إلى أن الهدف النهائي لهذا المشروع برمته منذ البداية هو جعل قطاع غزة بأكمله غير صالح للسكن، وإضعاف سكانه إلى درجة تجعلهم إما يموتون أو يبحثون عن جميع الخيارات الممكنة للفرار من الأرض. وبعبارة أخرى، فإن الخطاب الذي أطلقه القادة الإسرائيليون منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر يترجم الآن إلى واقع ملموس – أي كما تقول اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية لعام 1367هـ (1948م)، أن إسرائيل كانت تتصرف “بنية تدمير السكان الفلسطينيين في غزة كليا أو جزئيا”، “على هذا النحو، عن طريق القتل، أو التسبب في أضرار جسيمة، أو إلحاق ظروف معيشية تهدف إلى تدمير الجماعة”.
صحيفة الغارديان البريطانية




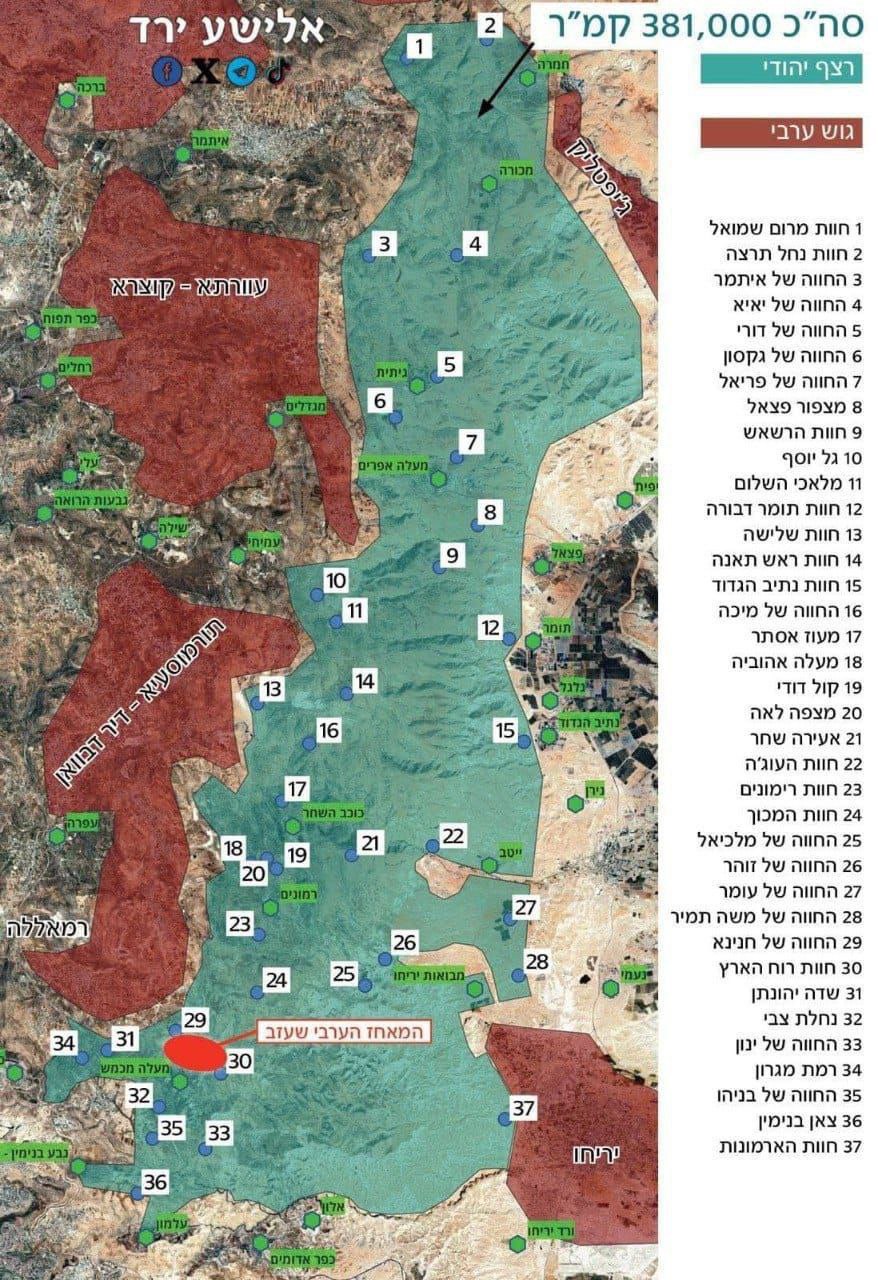
اترك تعليقاً