في ألمانيا وإيطاليا والسويد والدنمارك والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي… تضاعفت التدابير الجديدة ضد الهجرة في مختلف أنحاء أوروبا في السنوات القليلة الماضية. وتنمو هذه الظاهرة بالتوازي مع الصعود غير المسبوق للأحزاب والحركات اليمينية المتطرفة في أوروبا، والتي تجسد في نظر بعض الناخبين الحل لهذه “الآفة”. وفي مختلف أنحاء أوروبا يتغير المشهد السياسي على نحو لا يمكن تصوره منذ الحرب العالمية الثانية. ويبدو أن المجتمع الأوروبي ينغلق على نفسه، ويلقي باللوم على الهجرة في كل شروره. فهل هذا صحيح، أم أنه مجرد كبش فداء؟ وهل الهجرة تشكل حقا مشكلة في أوروبا؟ لنبدأ بقصة قصيرة.
تاريخ الدورات
في أواخر 1431هـ (أواخر عام 2010م)، وأوائل عام 1432هـ (2011م)، اندلعت الثورة في عدد من البلدان العربية. وفي حين يحاول البعض كبح جماح المد بالإصلاحات الاجتماعية أو القمع، يجرف آخرون في هذه الموجة. فواحدا تلو الآخر، أطاحت شعوب تونس وليبيا ومصر بالأنظمة الاستبدادية ووضعت حكومات ديمقراطية في مكانها. ولكن المقاومة المضادة للثورة التي أبداها أحد الأنظمة سوف تشكل بداية النهاية للربيع العربي. فرفض بشار الأسد السماح لشعب سوريا بأخذ مستقبله بأيديهم، وأطلق العنان للجحيم بدلا من ذلك. والقمع مروع، وتحولت البلاد إلى ساحة معركة. ومع تحول الحياة إلى أمر غير صالح للعيش، فر السكان السوريون، ليس فقط إلى البلدان المجاورة، بل وإلى أوروبا أيضا. ونزح ما بين 6 و8 ملايين شخص داخل سوريا وخارجها. ويمثل هذا نحو 60% من السكان الأصليين البالغ عددهم 13 مليون سوري. وفي عام 1436هـ (2015م)، بلغ الضغط على حدود أوروبا ذروته. وينتظر ملايين اللاجئين في تركيا للوصول إلى القارة. يتعين على الأوروبيين أن يختاروا بين الاستمرار في التظاهر بالجهل بالوضع، أو فتح الحدود. لقد اختارت المستشارة أنجيلا ميركل الإنسانية. وبصرخة “نحن هنا!” قررت الترحيب بأغلبية اللاجئين. لكن الدول الأوروبية الأخرى لا تحذو حذوها. ولا يبدو أن الترحيب باللاجئين يثير اهتمامها بنفس الدرجة.
كانت الأزمة الآن في جميع أنحاء أوروبا. ومع ذلك، لم يكن اللاجئون السوريون أقلية من إجمالي السكان النازحين فحسب، بل شهدت الدول الأوروبية أيضًا موجات أخرى من الهجرة، حتى قبل أن يبدأ المشروع الأوروبي. يشير مؤرخ الهجرة الفرنسي، باسكال بلانشارد، إلى أهمية هذه الظواهر، التي تعود إلى الثورة الفرنسية: “إن تأثير الهجرة هو جزء مكون من جميع اهتماماتنا […] والسؤال، في المقام الأول، ليس ما إذا كان هذا التأثير “إيجابيًا” أو “سلبيًا”، لأنه في المقام الأول وقبل كل شيء حقيقة. حقيقة محددة، كانت لأكثر من قرنين من الزمان جزءًا أساسيًا من هوياتنا، وديموغرافيتنا، والتغييرات في مناطقنا […] “. كانت الهجرة بالفعل ظاهرة دورية طوال القرنين التاسع عشر والعشرين. في حين شهدت أوروبا بالتأكيد هجرة جماعية خلال أزمات تلك القرون، إلا أنها رحبت بالمهاجرين في الغالب. في فرنسا، ساهمت الإمبراطورية الاستعمارية في نمو السكان العرب والسود في البلاد. وعلى نحو مماثل، أدى المهاجرون الوافدون من مستعمرات البلاد في آسيا وأفريقيا إلى تغيير تركيبتها السكانية.
ولقد شهدت أوروبا موجات من الهجرة بعد الحربين العالميتين. فقد سعت الأطراف المتحاربة التي مزقتها الحرب إلى إيجاد قوة عاملة دولية، أوروبية في المقام الأول. وعلى هذا فقد قدم العمال البرتغاليون والإسبان والبولنديون والبلجيكيون والإيطاليون يد المساعدة في إعادة بناء فرنسا وألمانيا. كما ناشدت فرنسا القوى العاملة في المستعمرات، فوسعت من حقوقها في الحصول على الجنسية الفرنسية. وكان الجزائريون والمغاربة على رأس هذه المجموعة، ثم السنغاليون والماليون. وبدأت ألمانيا في الترحيب بالسكان الذين أصبحوا أكبر جالية في أوروبا، وهم الأتراك. واستمدت بلجيكا المهاجرون من مستعمرتها المهمة في الكونغو. وباختصار، أصبح “البيض والمسيحيون” على نحو متزايد مجرد جزء من تركيبة المجتمع الأوروبي. واليوم، ينتمي أكثر من ربع الفرنسيين إلى أصول غير أوروبية. وما زال أحفاد العمال المهاجرين يعيشون في فرنسا ويحملون الجنسية الفرنسية. ولكن هذا الموقف من الانفتاح والرغبة في التكامل تحطم بسبب حدثين رئيسيين.
في فرنسا، فتحت حرب الاستقلال الجزائرية صدعًا في المجتمع: من ناحية، كان هناك القلب المستقبلي لحزب اليمين المتطرف، الجبهة الوطنية (FN)، الذي أراد إبقاء الجزائر في الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية، ومن ناحية أخرى كان هناك أولئك الذين آمنوا بتسوية الحجة باسم حق الشعب في تقرير المصير، حتى على حساب استقلال الجزائر ويلسون، 1337هـ (1919م). وعلى الرغم من اتفاقيات إيفيان لعام 1382هـ (1962م)، استمر العديد من الجزائريين في القدوم إلى فرنسا. فتحت اتفاقيات السلام الأبواب لهم، مع مزايا في الإجراءات والتكامل لم تُعرض على جنسيات أخرى. على سبيل المثال، منحت اتفاقية عام 1388هـ (1968م) المهاجرين الجزائريين وضعًا خاصًا في فرنسا. استفاد مواطنون آخرون من المستعمرات الفرنسية السابقة على نحو مماثل بعد حركات الاستقلال الخاصة بهم. وبينما كانت هناك بعض المعارضة للقادمين الجدد، إلا أنها كانت ضئيلة بشكل عام ولم تظهر إلا بين عدد قليل من الحركات التي كانت تحن إلى “فرنسا الكبرى”. بدأ المد يتحول مع أزمة النفط الأولى. في عام 1393هـ (1973م)، قررت الدول العربية التي كانت في حالة حرب مع “إسرائيل”، في ضربة قوية، فرض حظر على إنتاج النفط. ووصلت الأزمة إلى أوروبا. فقدت الاقتصادات الأوروبية الوقود، واضطرت الصناعات إلى تسريح العمال، وارتفعت معدلات البطالة. وانتهت “السنوات الثلاث المجيدة” بالهجوم الثلاثي المتمثل في العجز والتضخم وانخفاض الإنتاج.
وعاد اليمين المتطرف…لقد أفسح النمو المزدوج المجال للركود الأحادي. وتفاقمت الأزمات الاجتماعية. وواجهت الطبقة السياسية مرة أخرى مجتمعاً ممزقاً. ففي العام الذي سبق أزمة النفط، قام عضو سابق في منظمة فافن إس إس، بيير بوسكيه، وعضو سابق في جماعة بوجاد خدم مع الجيش الفرنسي في الجزائر، جان ماري لوبان، بتشكيل الجبهة الوطنية، وهو حزب يميني متطرف عنصري صريح، حنين إلى فرنسا الاستعمارية. وكانت أزمة النفط بمثابة حجر الأساس الأول لهذا الحزب الذي اتهم المهاجرين في ثمانينيات القرن العشرين بتفاقم محنة فرنسا من خلال سرقة الوظائف التي اعتقدوا أنه ينبغي تقديمها بحق للشعب الفرنسي. ولكن في حين تم تهميش جان ماري لوبان إلى حد كبير من قبل الطبقة السياسية والرأي العام، فقد مُنح فرصة ذهبية لدخول دائرة الضوء من قبل رئيس الجمهورية نفسه، فرانسوا ميتران.
اشتكى جان ماري لوبان من إسكاته، مدعيًا أنه مُنع من الوصول إلى منصات التلفزيون والصحف. من الضروري أن نضيف هنا أنه في هذا الوقت كان المجتمع الفرنسي لا يزال يعاني من صدمة جرائم النازيين على أرضه خلال الحرب العالمية الثانية. في وقت محاكمة ضابط الجستابو السابق كلاوس باربي (أول محاكمة لجرائم ضد الإنسانية تعقد في فرنسا) مثل اليمين المتطرف الشيطان المتجسد، وخطر العودة إلى الحرب. كتب لوبان إلى الرئيس للتنفيس عن مشاعره، شاكيًا من أن حركته “تُنبذ ” . رأى فرانسوا ميتران في وصول جان ماري لوبان إلى الساحة كفرصة لوضع عصا في عجلات اليمين المتطرف. قام بالمناورة ليظهر رئيس الجبهة الوطنية في عدد قليل من البرامج الصغيرة، وخاصة برنامج L’heure de Vérité [ساعة الحقيقة] في 12 جمادى الأولى 1404هـ (13 فبراير 1984م)، حيث كان لديه ما يقرب من ساعة ونصف الساعة لطرح معتقداته السياسية، بما في ذلك وجهة نظره بشأن المهاجرين.
ولكن في أوروبا، لم يكن هناك مجال كبير للنمو أمام الأحزاب اليمينية المتطرفة. فخلف الستار الحديدي، قمعت الأنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية الأصوات المعارضة، بما في ذلك أصوات اليمين المتطرف. ولم يكن هناك مجال للسماح لغرغرينا الفاشية بإفساد “القضية العظيمة لتحرير الشعب” التي كانت الشيوعية. وباعتبارها أحد الأطراف الرئيسية في الحرب العالمية الثانية، راقبت ألمانيا عن كثب تطور الحركات اليمينية المتطرفة المحتملة، من أجل منع اندلاع حرب أخرى في البلاد. وحتى اليوم، لا تزال مراقبة الأحزاب التي تعتبر “يمينية متطرفة” صارمة والقمع قويا. ومع ذلك، لم يمنع هذا حزب البديل من أجل ألمانيا من تحقيق النجاح الانتخابي وحتى تعزيز مكانته في البوندستاغ. لقد تصرفت المملكة المتحدة على نحو مماثل، بعد أن أصيبت بصدمة بسبب دعم اتحاد الفاشيين البريطانيين لهتلر تحت قيادة أوزوالد موزلي، وبسبب الروابط بين الملك السابق إدوارد الثامن وكبار الشخصيات النازية. ومع ذلك، هناك الآن حركات يمينية متطرفة صغيرة الحجم في جميع أنحاء البلاد. تعد إسبانيا والبرتغال، اللتان كانتا تحت حكم ديكتاتوري حتى سبعينيات القرن العشرين، من بين الدول الوحيدة التي شهدت اليمين المتطرف كقوة سياسية رئيسية. وهو النمط الذي تحررت منه الدولتان بسرعة بعد سقوط الجنرال فرانكو وسالازار.
ورغم أن التاريخ علمنا مخاطر استيلاء الحركات اليمينية المتطرفة على السلطة، فإن الاضطرابات السياسية والاجتماعية في القرن الحادي والعشرين جلبت مع ذلك عودة عدد من هذه الأحزاب، في كل مكان تقريبا في أوروبا. وفي محادثة مع لو توريلون، أعلنت فابيان كيلر، عضو البرلمان الأوروبي عن مجموعة تجديد أوروبا ومقررة البرلمان الأوروبي بشأن قضايا الهجرة، أن الهجرة “هي الوقود” لهذا المحرك القديم، الذي يعود إلى العمل مرة أخرى. وكانت أزمة اللاجئين في الفترة 1436-1439هـ (2015-2018م) بمثابة دفعة خاصة له. ولكن انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في عام 1437هـ (2016م) هو الذي فتح صندوق باندورا. وبينما كانت الديمقراطيات الليبرالية في العالم تترنح أمام النتيجة، كان الزعماء والمرشحون القوميون والسياديون يفركون أيديهم في انتظار ما سيحدث. ومنذ تلك اللحظة فصاعدا، لم يعد الوصول إلى السلطة العليا وهمًا بل أصبح احتمالًا حقيقيًا. الدليل: أن القوة العظمى في العالم، وزعيمة العالم الحر، والديمقراطية النموذجية في العالم، فتحت أبوابها لزعيم شعبوي راسخ في اليمين.
لا تزال الهجرة تشكل هوساً أكبر من أي وقت مضى بالنسبة للحركات اليمينية المتطرفة في أوروبا التي تسعى إلى الدفاع عن “أسلوب الحياة الأوروبي”. وتجد أفكارها صدى. وهي تترسخ في أذهان المزيد والمزيد من الناخبين، غالباً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وقد ضربت أوروبا بقوة، انتخابات تلو الأخرى، طوال عشرينيات القرن الحادي والعشرين. وتحولت السويد وفنلندا، الديمقراطيتان الاجتماعيتان المعتادتان، إلى اليمين. وشهدت هولندا، التي كانت ذات يوم معقلاً للديمقراطية الليبرالية، فوز خيرت فيلدرز بأغلبية الأصوات. واختارت سلوفاكيا إعطاء اليمين المتطرف فرصة للمشاركة في الحكومة. ونصبت إيطاليا قوميين على رأس الحكومة للمرة الثالثة في تاريخها. وقد خاض الجميع حملة بهدف واحد: الحد من الهجرة بهدف منعها بشكل كامل، ووصفها بأنها سبب الأزمات الاجتماعية، وخطر على المجتمع الأوروبي، وناقل لعدم الاستقرار. وأصبح تفكيك مثل هذا الخطاب أكثر صعوبة، حيث أصبحت عقول المزيد من الناس مرتبطة بهذه الصورة الكاريكاتورية. ومع اقتراب موعد الانتخابات الأوروبية، من الأهمية بمكان تفكيك الصور النمطية، وإعادة إرساء الحقيقة، وتحديد التناقضات في ادعاءات اليمين المتطرف، وإلقاء الضوء في النهاية على هذه الظاهرة التي لا يُفهم الكثير منها بشكل جيد.
Le Taurillon.




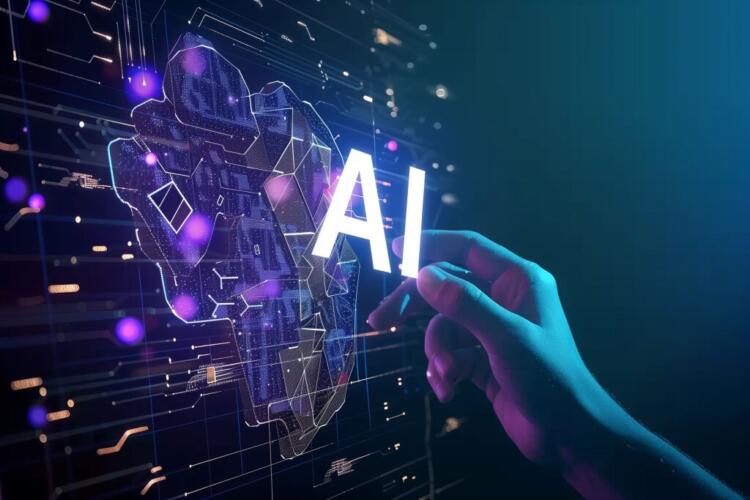
اترك تعليقاً